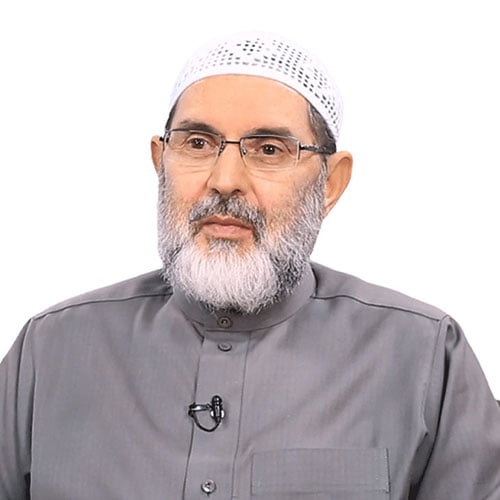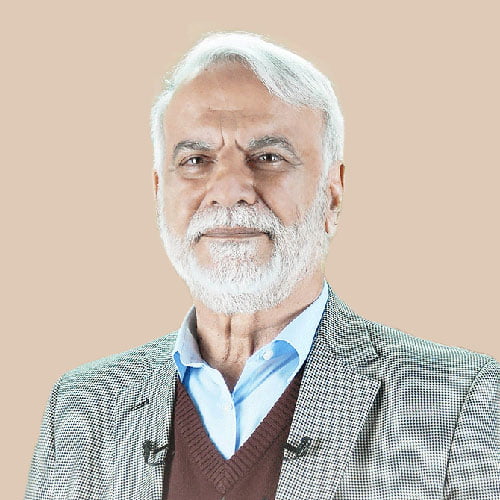بقلم الأستاذ أحمد الكودي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
من حكمة الله عزّ وجلّ أن تتقلّب أحوال الأمم والمجتمعات بين صعودٍ وهبوط، كما تتقلّب أحوال الأفراد بين قوّةٍ وضعف، واستقرارٍ واضطراب. وكما يمرّ الفرد بأزماتٍ تربكه وتدفعه للبحث عن سبيلٍ للنجاة، تمرّ المجتمعات كذلك بتحدياتٍ كبرى تهزّ بنيتها، وتضعها أمام أسئلةٍ مصيريةٍ لا مفرّ من مواجهتها.
ومن طبيعة الأزمات العميقة التي تصيب الأمم أن تستدعي سؤالين مركزيين:
سؤال المخرج: كيف نخرج من واقع الأزمة؟ ومن أيّ طريقٍ يكون العبور؟
وسؤال الغاية: إلى أيّ أفقٍ نريد أن نصل؟ وما الهدف الأكبر الذي ينبغي أن نتحرّك في ضوئه؟
وحين تفقد الأمة القدرة على صياغة جوابٍ واضحٍ لهذين السؤالين، تدخل في حالةٍ من التيه، والصراع، والتردّد، ويُدفع ثمن ذلك من أعمار الأجيال القادمة قبل الحاضرة. فلا يُغني أحدُ السؤالين عن الآخر؛ إذ لا معنى لمخرجٍ بلا غاية، ولا جدوى من غايةٍ بلا طريق.
ومن تمام عافية الأمم، وحُسن وعيها بذاتها ورسالتها، أن تمتلك تصوّرًا واضحًا عن غايتها الكبرى، بقدر ما تنشغل بالبحث الجادّ عن مخرجٍ من أزماتها. وإن كان سؤال الغاية أسبق وأعمق أثرًا، فإن سؤال المخرج يظلّ لازمًا بقدر رفض الأمة لواقعها المختلّ، وسعيها الصادق إلى تغييره.
وإذا أردنا أن نرى هذا المعنى متجسّدًا في التاريخ، فإن موقف أبي بكرٍ رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة يُعدّ من أعمق النماذج التطبيقية على وعي الأمة بسؤال الغاية وسؤال المخرج معًا.
الاجتماع في سقيفة بني ساعدة:
لمّا علم الصحابة بوفاة رسول الله ﷺ، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة في اليوم نفسه، وتداولوا الأمر بينهم في اختيار من يلي الخلافة من بعده، والتفّ الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه. ولمّا علم المهاجرون باجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، شعروا بخطرٍ داهمٍ يمكن أن يشقّ عصا المسلمين، ويشتّت جهودهم، ويمزّق وحدتهم، ويهدّد كيان دولتهم.
وكان بإمكان المهاجرين عقد مؤتمرٍ خاصٍّ بهم، والبحث في الموضوع وحدهم، ولكن من حِنكتهم السياسية، ورجاحة عقولهم، وفطنتهم، وحكمة أبي بكرٍ وعمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم، حرصوا على الحضور مع إخوانهم لمواجهة الأمر بالعقل والتدبير الحسن.
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. قال عمر رضي الله عنه: والله لنأتينّهم؛ لأن مصلحة الأمة فوق كل مصلحة، ولا بدّ من الشورى. ولو لم يحضروا لحدث واحدٌ من الأمرين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلًا منهم بعدنا، فإمّا بايعناهم على ما نرضى، وإمّا نخالفهم فيكون فساد» (علي محمد الصلابي، بناء الدولة المدنية بعد وفاة الرسول الكريم ﷺ، حادثة السقيفة، مدونة الجزيرة، 2019).
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ مات، وأبو بكرٍ بالسُّنح – قال إسماعيل: يعني بالعالية – فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله ﷺ. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلّا ذاك، وليبعثنّه الله فليقطعنّ أيدي رجالٍ وأرجلهم.
فجاء أبو بكرٍ، فكشف عن رسول الله ﷺ فقبّله، وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيًّا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يُذيقك الله الموتتين أبدًا. ثم خرج فقال: أيّها الحالف، على رسلك.
فلمّا تكلّم أبو بكر، جلس عمر، فحمد الله أبو بكر، وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حيٌّ لا يموت. وقال: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30]. وقال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: 144].قال: فنشج الناس يبكون
قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منّا أمير، ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكرٍ، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح.
فذهب عمر يتكلّم، فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلّا أنّي قد هيّأت كلامًا قد أعجبني، خشيت ألّا يبلغه أبو بكر.
ثم تكلّم أبو بكر، فتكلّم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء.
فقال الحباب بن المنذر: لا والله لا نفعل؛ منّا أمير، ومنكم أمير.
فقال أبو بكر: لا، ولكنّا الأمراء، وأنتم الوزراء؛ هم أوسط العرب دارًا، وأعربهم أحسابًا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح.
فقال عمر: بل نبايعك أنت؛ فأنت سيّدنا وخيرنا، وأحبّنا إلى رسول الله ﷺ.
فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايعه الناس.
فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة.
فقال عمر: قتله الله.
(صحيح البخاري، 3667).
فالمتأمّل في هذا المشهد يدرك عِظَم فقه أبي بكر، وحسن تقديره لخطورة اللحظة؛ إذ بادر بتذكير المسلمين بأصل الغاية التي قامت عليها هذه الأمة، وهي تحقيق العبودية لله، وربط الاجتماع والطاعة والقيادة بهذا المعنى الجامع، ليجيب بذلك عن سؤال: لماذا نتحرّك؟ وعلى أيّ أساسٍ نقيم أمرنا؟ثم انتقل وعي الصحابة – رضوان الله عليهم – إلى السؤال العمليّ الملحّ الذي فرضته الأزمة الواقعة، وهو سؤال الاستخلاف: من يتولّى أمر الأمة بعد رسول الله ﷺ؟ وكيف يُصان كيانها من التفرّق والاضطراب؟
فلم يكتفوا باستحضار الغاية، بل سعوا في اللحظة نفسها إلى إيجاد المخرج المناسب الذي يحفظ وحدة الجماعة، ويؤمّن مستقبل الدعوة.
ولو توقّف الصحابة عند سؤال الغاية وحده، أو تأخّروا عن الإجابة عن سؤال الأزمة في حينها، لكانت العواقب وخيمة على المجتمع المسلم الناشئ، وربما امتدّ أثر ذلك إلى مستقبل الإسلام كلّه.
لكن اجتماع الوعي بالغاية، مع المبادرة للإجابة عن سؤال المخرج، كان سببًا في تجاوز أخطر لحظةٍ انتقاليةٍ عرفتها الأمة.
ومع مرور الأزمنة، قد يختلف المسلمون في تشخيص أزمات واقعهم، أو في تحديد أنسب السبل للخروج منها، لكن لا ينبغي لهم أبدًا أن يفصلوا بين السؤالين، ولا أن يكتفوا بجواب أحدهما عن الآخر.
فسؤال الغاية: ماذا نريد؟ سؤالٌ ثابت، وجوابه ثابت، يدور حول العبودية والاستخلاف عن الله في الأرض.
أمّا سؤال الأزمة: ما الذي نعيشه الآن؟ وكيف نتجاوزه؟ فهو سؤالٌ متغيّر بتغيّر الأحوال، وتتغيّر معه الإجابات والوسائل، دون أن تمسّ الثوابت.
منذ سقوط الخلافة تقريبًا، لم يتوقّف العلماء والمفكّرون عن البحث في سؤال الأزمة التي تعيشها الأمة. وتنوّعت الإجابات بتنوّع الزوايا التي نُظر منها إلى الواقع، غير أنّ من أكثرها شيوعًا وانتشارًا القول بأن أزمتنا الكبرى هي ضعف الإيمان.
ومع ما في هذا الجواب من حقٍّ من حيث الأصل، إلّا أنّه يظلّ جوابًا غير كافٍ من حيث التشخيص؛ إذ يصعب تفسير حالة الضعف الحضاري الشامل بمجرّد ضعف الإيمان، خاصّةً إذا علمنا أنّ الأمة – في أشدّ مراحل تراجعها – لا تزال من حيث الجملة أكثر تمسّكًا بالإيمان من أممٍ كافرةٍ لا تؤمن بالله أصلًا، ومع ذلك تمتلك فاعليةً تاريخيةً وعلميةً وحضاريةً أعلى.
إن تكرار هذا الجواب، وقبوله الواسع في الأوساط الدعوية، لا يجعله بالضرورة جوابًا دقيقًا على سؤال الأزمة، بقدر ما يكشف عن ميلٍ للاكتفاء بالتفسير الوعظي، بدل الغوص في التشخيص المركّب للواقع.
وفي مقابل هذا التفسير، برز اتجاهٌ آخر يرى أنّ الأزمة في جوهرها هزيمةٌ حضارية؛ أي تراجع فاعلية الأمة في التاريخ، والعلم، والعمران، وانحسار قدرتها على الإبداع والتأثير، لا بسبب ضعف التدين، بل بسبب الابتعاد عن روحه المقاصدية، مع تفكّكٍ داخليّ، وصراعاتٍ مستمرّة، وتبعيةٍ فكريةٍ وسياسية، وإهمالٍ منهجيٍّ لبناء الإنسان والمعرفة.
وقد نتج عن ذلك ضعفٌ شامل، وعجزٌ عن مواكبة العصر، ما استدعى الدعوة إلى تجديد البنية الثقافية للأمة، واستعادة الثقة الواعية بالموروث، والجمع بين أصالة التصوّر الإسلامي، ومكتسبات العلوم والمعارف المعاصرة، بوصف ذلك شرطًا لازمًا لأيّ نهضةٍ حضاريةٍ حقيقية.
إن طائفةً من المفكّرين، الذين تميّزوا بالاطلاع على حضارة الغرب في موطنها، وأدركوا موطن القوّة لدى الأوروبيين، أدركوا أنّ الأزمة لا تكمن فقط في بُعد المسلمين عن دينهم، وإنّما تكمن أيضًا في أنّهم انكمشوا، وجمدوا، وكفّوا عن التطوّر الذي تتيحه العلوم والمعارف، وتساعد عليه وسائل الإنتاج المادية، والمؤسّسات الاقتصادية القوية، والاحتكاك بالأمم، والإفادة من تجاربها، ومنافستها في تقدّمها.
كما أدركوا أنّ روح الإسلام وشريعته لا تتعارض مع أسس التقدّم والتطوّر في المجتمعات الحديثة، وأنّ سبب تخلّف المسلمين يعود إلى الاستبداد، والجهل، والجمود الفكري.
كان على رأسهم مالك بن نبي؛ كان عميقًا في تحليله لواقع المسلمين، وفي معرفته بخبايا الاستعمار والمستعمرين، وفي معاناة الشعوب الإسلامية، وأثار قضايا كبيرة، مثل الحديث عن الدورة الحضارية، ومسألة الحقّ والواجب، والقابلية للاستعمار، والفاعلية.
أصدر مؤلّفاته تحت عنوان «مشكلات الحضارة»، وكلّها تصبّ في همّه الأكبر، وهو: كيف يدخل المسلمون دورةً حضاريةً جديدة؟ وذلك من منطلق أنّ مشكلة أيّ شعبٍ هي في جوهرها مشكلةٌ حضارية.
وفي هذا السياق، تبرز إشكاليةٌ معاصرة لا يمكن تجاوزها؛ إذ نسمع أحيانًا أصواتًا تعلو من بعض الدعاة تحثّ الناس على الاكتفاء بالانشغال بسؤال الغاية، مع التزهيد الصريح أو الضمني في البحث عن إجابةٍ لسؤال الأزمة الحضارية التي تعيشها الأمة.
وهنا يفرض العقل والمنهج معًا تساؤلًا جادًّا: هل يمثّل هذا المسلك استجابةً صحيحةً تعين الأمة على نهوضها، أم أنّه اختزالٌ مخلٌّ لسنن التغيير؟
فلو أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه اقتصر دوره في السقيفة على التذكير بالعبودية، دون أن يتكاتف مع الصحابة للإجابة العملية عن سؤال الخلافة، فهل كان يمكن للأمة أن تتجاوز تلك اللحظة الحرجة؟ وهل كان الإسلام ليصل إلينا على الصورة التي نعرفها اليوم؟ إنّ التاريخ لا يجيب عن هذه الأسئلة افتراضًا، بل يجيب عنها واقعًا.
كما أنّ الإجابة عن سؤال الحضارة، وتشخيص أزمات الواقع، والسعي إلى تجاوزها، لا تُعدّ التفاتًا عن كليّات الشريعة، ولا خروجًا عن مقاصدها، بل هي من تمام تنزيلها في الواقع، ومن صميم فقه الاستخلاف الذي به تُصان الغايات، وتُحفَظ الثوابت.
وعليه، فهل يصحّ أن تُقسَّم الأدوار داخل الأمة على نحوٍ تكون فيه فئةٌ تُرسّخ سؤال الغاية في وعي الناس، وأخرى تُفتح لها نافذة البحث في سؤال الأزمة؟ والواجب أن يلتقي السؤالان في وعيٍ واحد، ومنهجٍ واحد، يجمع بين ثبات الغاية، ومرونة الوسائل، وصدق السعي في تنزيل الهدي الربّاني على واقعٍ متغيّر.
ومن الإشكالات الكبرى في فهم سؤال الأزمة، فيما يخصّ أزمتنا المعرفية، أنّنا نتعامل مع المعرفة وكأنّ لها طريقًا واحدًا، بينما تراثنا نفسه يقرّر أنّ لله كتابين: كتابًا مسطورًا يُتلى، وكتابًا منظورًا يُنظر فيه.
فالقرآن نصٌّ يهدي، والكون، والإنسان، والتاريخ آياتٌ نفهم بها الواقع. ويبدأ الخلل حين نحصر الفهم في أحد الكتابين دون الآخر.
واللافت أنّ كثيرًا من النظريات الغربية الكبرى نشأت من النظر في «الكتاب المنظور»: في الإنسان، والمجتمع، والاقتصاد، والنفس، والسلطة. تأمّلوا الواقع، وراكموا الملاحظة، وأخطؤوا وأصابوا، ثم خرجوا بتفسيراتٍ لما يحدث حولهم.
أمّا نحن، فكثيرًا ما نبحث عن سؤال الخلل أو الأزمة في «الكتاب المسطور»: هل طلبًا للهداية، أم هروبًا من السؤال نفسه؟
وقد يتحوّل الوحي من أداةٍ للفهم والكشف إلى وسيلةٍ لإغلاق النقاش، وكأنّ النظر في الواقع صار موضع ريبة، والتفكير في أسباب التراجع ضعفًا في الإيمان، مع أنّ الجمع بين الكتابين هو جوهر الإيمان نفسه.
فالوحي الذي دعا إلى التدبّر هو ذاته الذي أمر بالسير في الأرض والنظر: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا﴾.
وحين لا يلتقي الكتاب المسطور بالكتاب المنظور، يدور سؤال الأزمة في حلقةٍ مكرّرة، وتتكرّر الإجابات، ويغيب الفهم الحقيقي.
نسأل الله العظيم أن يهيّئ لأمتنا أمر رشد، وأن يجعلنا صالحين مصلحين.